نزق التأريخ في الدراما المصرية..... حلية أم إكسسوار؟
لا عجب في ذلك الهوس الذي أصاب كتّاب المعالجات الدرامية المصريين بالنهل من التاريخ. ربما لا يجد البعض جدة في ذلك المنحى، فالدراما المصرية ربما بنت مجدها من التاريخ. المتابع الجيد يكتشف أن الدراما التاريخية القديمة (الفرعونية والإسلامية) كانت تحديداً بداية إرهاص الريادة المصرية منذ بداية الثمانينات عصر التلفزيون المصري الذهبي. حتى النجاحات المدوية للدراما الاجتماعية المصرية لم تعرف زهوها إلا حين مارست الدراما دورها في نقد السياسي والاجتماعي التاريخي بعيداً عن سرديات التاريخ المباشرة. "ليالي الحلمية" هي سردية درامية أولى لتاريخ مصر السياسي لمدة قرن في دراما اجتماعية، ثم توالت نجاحات الدراما الاجتماعية المستندة الى رافعة التاريخ السياسي في مسلسلات المال والبنون والعائلة وربما، قبلهما، في الاحتكاك اللامباشر كما فعلها مسلسل "الشهد والدموع". نلحظ بشكل ما أن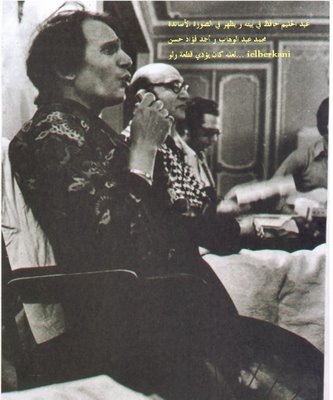 السيناريست أسامة أنور عكاشة مثّل ملكاً متوجاً لذلك المنحى، هو الفاشل في الكتابة الروائية دخلت معه الدراما المصرية مرحلة "الرواية التلفزيونية" مستمداً من تراث نجيب محفوظ القدرة على بناء الشجرة العائلية الممتدة والخطوط الدرامية المتقاطعة. كان أسامة الساحر الأول لتلك النوعية عندما جعل خطوطه الدرامية البعيدة عن الزخرفة تتقاطع بحنكة مدربة مع ما هو سياسي. والمتابع لسردية "ليالي الحلمية" المبنية على منظومة التداخلات الطبقية للحي الشهير، والتي تربط بوشائج عنيفة علاقات ساكني قصوره بالحارات الخلفية، يدرك إحدى أهم سمات الاشتباك الاجتماعي السياسي فاعلية في الدراما المصرية. لكن الفاصل بين "ليالي الحلمية" نهاية الثمانينات وما اتخذه الخط البياني للدراما المصرية بعدها إلى الآن، هو محصلة فارق الموهبة الضخمة بين المبتكر الأول (أسامة أنور عكاشة) وبين من تتلمذوا على يديه من ناحية، كما هو الفارق بين لحظة إنتاج العمل الأول سياسياً واجتماعياً وبين اللحظات التالية وحتى الآن. فالمجتمع المصري شهد فيما بين اللحظتين تحولات عنيفة أصبحت الدراما خلالها تلعب أدواراً متباينة وفقاً لتغير ذوق الجمهور الذي تخاطبه، كذلك دخل عامل المنافسة غير المتكافئة مع انتاجات الدراما المحيطة اقليمياً دوراً في تعليب ذوق المصريين في أنماط بعينها تخص صورهم عن ذاتهم وما يأملون في مشاهدته عن أنفسهم. الدراما الاجتماعية، منذ منتصف التسعينات، تنحو الى التلصص على عوامل النخب الاقتصادية الجديدة والتي لن يشاهدها مواطن عادي في شوارع القاهرة، بل يمكن أن يتأقلم معها في مسلسلات عن الشر والرشاوى وعالم رجال الأعمال المشوه الذي هو في النهاية "شغل مسلسلات". كما اتجهت شريحة أخرى من المسلسلات لمخاطبة الحلم التقليدي للصعود الطبقي ممثلاً في تاجر خردة يصعد بالكفاح كما في "لن أعيش في جلباب أبي"، أو توجهت شريحة أخرى للمراهنة على المسلسلات ماركة "الترزي البلدي" وهي المسلسلات التي تعتمد على تفصيل 22 ساعة درامة على مقاس نجم أو نجمة.التاريخ يعود هذا العام في أكثر من موضع للدراما المصرية، سنتكلم هنا فقط عن العملين الأضخم انتاجياً وهما مسلسلي "حليم... حكاية شعب" و"السندريلا" بوصفهما مسلسلين يتخذان من التاريخ عمداً إحدى ركائزهما، ليس فقط بحكم كون عبدالحليم حافظ وسعاد حسني ينتميان لسردية تاريخية واحدة تتعلق بفترة من التاريخ المصري تمتد من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهايته، ولكن في ما قبل ذلك وبعده لذلك الإصرار من جانب مؤلف المسلسلين على تقديم كادر تاريخي متسع ينظم علاقة موضوع المسلسلين (سعاد حسني وعبدالحليم) بالأوضاع السياسية والإجتماعية التي تطورت كاريزماتهما ضمنها. من البداية وعبر اختيار عنوان مسلسل حليم عطفاً على "حكاية شعب"، يضع مدحت العدل مؤلف العمل مهمة ثقيلة على عاتقه، حيث يقدم العالم السياسي والاجتماعي المحيط بتطور موهبة عبدالحليم، لا في مداخلات محسوبة كماً وكيفاً من نص المسلسل، ولكن بأقرب الى سردية موازية ومتقاطعة عن عمد مع حياة عبدالحليم. السينارست هنا، وهو يتعامل مع شخصية لا تنتمي الى مرجعية نصية ممثلة في مذكرات مكتوبة بيد حليم، أو حتى في نص مكتوب لسيرته تحت إشرافه مضطر للسباحة الخطرة بين سيرورة تعتمد على نص شفاهي بامتياز، ممثلة في مقتطفات الصحف والمقابلات الإذاعية والصحافية أو ما ورد على لسان غيره. لم نعرف مرجعاً شاملاً أو كاملاً لشخصية عبدالحليم الحقيقية، خصوصاً في ما يتعلق بحياته قبل نجوميته الزاعقة. لذا يبدو الحديث عن طفولته درامياً رهين الخيال الرومانتيكي عن إبن قرية "الحلوات" اليتيم وعائلته الفقيرة، وهي الدراما التي استطاع حليم نفسه أن يكرسها في الأذهان لاحقاً وعبر مسيرته الطويلة. إلا أنها وحدها ربما ونتيجة لفقرها الشديد وإيجازها المخلّ لا تصلح وحدها لملء فراغات تلك السردية. هنا كان لا بد من اللحاق بنصوص ذات وجاهة درامية فاقعة تتمثل في الحراك السياسي في القاهرة ممثلاً في أنشطة حسن البنا وجماعة الإخوان والوفد والشيوعيين. وكأن ابن القرية البعيدة الواقعة في شرق الدلتا كان مدركاً لطبيعة تلك الصراعات العنيفة في مدينة نجوميته المستقبلية.المؤسف بحق أن الشخصية الحقيقية المترسبة عبر التاريخ لحليم ربما لا ترشح مثل هذا التناص. فما عرف عن النجم الراحل كان عدم اهتمامه بالسياسة أساساً، وتحديداً كان ذلك من عوامل الجذب الشديدة في شخصيته عندما اختارته الثورة بشكل تقاطعي ليصبح صوتها الأهم. يبذل السينارست مجهوداً شكلانياً جباراً لربط مسيرة حياة المطرب الناشئ بالتطور الذي نتوقعه له مستقبلاً. فنرى حسن البنا وعلاقاته التنظيمية لأول مرة على شاشة مصرية عروجاً على علاقة تعاطف بعيدة لأحد أقارب حليم مع أفكار جماعة الإخوان المسلمين. هل هو الميل الى التأريخ من دون مناسبة ما يدفع مدحت العدل لتشبيك تلك الخطوط الواهية درامياً ببعضها البعض؟ أم أن غموض تلك المرحلة في شخصية حليم احتاجت الى حشو ذي نبرة عالية للتغطية على الفجوات العميقة والحقيقية؟ الأزمة لدى مدحت العدل متأصلة في ذلك الجنوح الى التأريخ، فالعام الماضي قدم مسلسلاً بعنوان "محمود المصري" ابتدع خلاله حشواً تاريخياً ممجوجاً لقصة الصعود الطبقي لأحد الكرتلات الاقتصادية المصرية في الخارج ـ أشيع أنها قصة الملياردير المصري محمد الفايد صاحب سلسلة محلات هاوردز اللندنية الشهيرة ـ حيث التقاطعات السردية مع فساد مصر الملكية ثم مصر الجمهورية الناصرية ثم العودة لفساد السبعينات التي مثلت الخلفية لهروب ثم عودة ثم هروب الشخصية الرئيسية. مع كامل الإكسسوار الذي يبدع من خلاله مدحت العدل حين يعرج على التنظيمات اليسارية في السبعينات من خلال شخصية فرعية، ولإكمال المشهد، لا بد من راكور الشاب المتطرف دينياً، والكل لخدمة ضعف الحكاية الدرامية البسيطة لصعود بطله محمود المصري.التاريخ كحالة إكسسوارية يطفح هذه المرة مع حليم، ويجري تعميقه من خلال ضبط شكلاني مريع في دقته: الملابس والديكورات والتقمص الشكلاني للممثلين في أدوار ثانوية أحاطت بحليم مثل كمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وصلاح جاهين، هذه الأسماء الضخمة، بالإضافة للسياسيين والصحافيين الكبار والتي بالغ المخرج في استعراض حجم المطابقة الشكلية للممثلين مع أصحابها، يجعل من مسلسل حليم عرضاً للمشخصاتية، حيث يحاول ناسج الخطوط الدرامية أن يضع في كل مشاهده تلك الإيقونات في أبهى حللها وكأنه يبحث عن تفخيم مبالغ فيه للعمل. كل الشخصيات تنطق بروح المشخصاتي لا الممثل، مشاهد كاملة داخل الحلقات المعروضة حتى الآن مفتعلة افتعالاً غير مسبوق، وكأن المخرج والسينارست يحاولان التعمية على ضعف أداء الشخصية الرئيسية والتي يقدمها الممثل شادي شامل. هذا الأخير هو أكبر مصائب المسلسل حيث لم يخرج بالشخصية من على مسرح المقلداتي. لم ينزل شادي شامل حتى الآن من على مسرح قناة الـ"إم بي سي"، لم يبحث مثلاً كيف كان أداء حليم الشخصي فيزيقياً ومشاعرياً خارج طلته الكاريكاتيرية على المسرح وهو يغني في نهاية عمره. ليس من الممكن أن يكون حليم بهذه التفاهة التي تطالعنا في كل مشهد يطل من خلاله شادي شامل، ذلك التهتك المبتذل والمكياج الصاخب الذي يصاحبه حتى وهو نائم في فراشه قبل أن يشتهر، في أحد المشاهد تدخل عبلة كامل ـ إحدى الفضائح التقليدية الآن في الدراما المصرية ـ التي تقوم بدور شقيقة حليم "علية" لتوقظه من النوم، فيطل علينا حليم بكامل شعره المصفف والمسشور من تحت البطانية حتى قبل أن يفرك عينه. ما أن يطل شادي شامل بأراجوزية أدئه الطافحة حتى تشعر بأن المسلسل بكامله في مقام المسلسل الكوميدي أو كفقرة تقليد السينما على إحدى القنوات الفضائية. ولا بد هنا من القياس فقد قدمت الدراما المصرية منذ ما يزيد عن العشرين عاماً مسلسل "الأيام" المأخوذ عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين. وعلى الرغم من فارق الإمكانات المادية والتقنية بين اللحظتين، لكننا حتى هذه اللحظة، وعند تخيل عميد الأدب العربي، نحتاج لفصله بقوة عما قدمه العملاق أحمد زكي. لم يلجأ كاتب دراما "الأيام" لأي إكسسوار تاريخي خارج نص العميد، الحياة الشقية والفقيرة للطفل طه حسين وصراعه مع المرض والعمى. رغم بساطة الطاقة الدرامية فقد تسمرنا أمام المسلسل لنحو عشر حلقات كاملة. أعرف أن المقارنة بعمل يعود بسرديته الى نص أدبي بديع مثل "الأيام" مقارنة ظالمة، إلا أن الأداء المبهر لأمينة رزق ويحيى شاهين والطفل شريف عبدالمحسن، ثم أخيراً ومن خلف الجميع، العملاق أحمد زكي، ثم المقادير الدرامية المبثوثة عبر تدرجات العمل، ألزمت ذاكرتنا على حفظ جمل طويلة من حواراته ومشاهده. أين هذا من مسلسل تدخل حلقاته الى منتصف الشهر دون أن يستطيع إقناعنا بأن من نراه على الشاشة هو عبدالحليم حافظ بكل مدلولات الكلمة من سحر وتشويق. المعالجة الدرامية التي تتعكز على التاريخ السياسي دون مبرر تُبهت ربما عن عمد إطلالات حليم المزيف. فإذا ما أضفنا بهوت وكلاشيهية معالجة ذلك التاريخ حين ينحصر دور المعالجة في تلبيس ما هو شفاهي من سردية تلك الأيام ثوب واقعية ممجوجة بمكياج ثقيل ومقاربات شكلية لأبطال المرحلة منزوعة الروح والسياق، تجعلنا أمام إسكتش هزلي للتاريخ بحجم مسلسل طويل مملّ. في الحلقة التاسعة من المسلسل، وبعد متتالية مشاهد لرحلة حليم الفاشلة للغناء بالاسكندرية عام 1951، يتذكر المؤلف محور "ثورة يوليو" فيعود للضباط الأحرار في متتالية ثانية وطويلة هي الأخرى تبدأ بعبد الناصر منتظراً نتيجة انتخابات نادي الضباط ثم حوارمع زوجته، ثم بخروجه من المنزل تحت المراقبة، ثم بهروبه من المراقبة، ثم بلقائه قيادات الضباط الأحرار شارحاً ضرورة التحرك السريع للقيام بالثورة مع تقطيع مواز للسرايا حيث قيادة البوليس تخطط للقبض عليهم، ثم العودة الى محاولات ناصر ورفاقه مواجهة الملك. من يفتح التلفزيون منذ عشر دقائق على الأقل وحتى نهاية الحلقة سيعتقد أن المسلسل عن ثورة يوليو، أين حليم من هذا؟ ثم لماذا الإصرار على ربط حراك حليم وصعوده قبل الثورة برباط الوطنية. في أحد المشاهد التي تؤكد على آلية الربط اللامنطقية يسأل حليم أخاه الضابط عن هموم الجيش، فيخرج الأخ بياناً للضباط الأحرار، فيتنبأ حليم بالثورة؟ ليس هناك بالطبع أي مرجعية تاريخية تؤكدأو تنفي هذا المشهد، فالمشهد مبتكر في فجاجته ويخص الخيال التلفيقي لمدحت العدل. ويبدو أن الجمهور الذي يتعامل مع تلك المرحلة على أنها حلم، هذا الجمهور تحديداً قد أصبح مؤهلاً لتجاوز ركاكة وهشاشة المزج المتعمد بين أرجوز على هيئة حليم وبين الثورة والفن والسياسة، فخلاّط الدراما المصرية لا جناح عليه طالما تاريخ تلك المرحلة نفسها قد تُرك عمداً في غياهب ضباب كثيف. تركت فترة الأحلام الكبرى عرضة لهزل الأحفاد، تُركت كي تتحول على شاشة الإعلانات الى فاصل درامي يتعامل مع التاريخ كإكسسوار براق لبيع بضاعة فاسدة.
السيناريست أسامة أنور عكاشة مثّل ملكاً متوجاً لذلك المنحى، هو الفاشل في الكتابة الروائية دخلت معه الدراما المصرية مرحلة "الرواية التلفزيونية" مستمداً من تراث نجيب محفوظ القدرة على بناء الشجرة العائلية الممتدة والخطوط الدرامية المتقاطعة. كان أسامة الساحر الأول لتلك النوعية عندما جعل خطوطه الدرامية البعيدة عن الزخرفة تتقاطع بحنكة مدربة مع ما هو سياسي. والمتابع لسردية "ليالي الحلمية" المبنية على منظومة التداخلات الطبقية للحي الشهير، والتي تربط بوشائج عنيفة علاقات ساكني قصوره بالحارات الخلفية، يدرك إحدى أهم سمات الاشتباك الاجتماعي السياسي فاعلية في الدراما المصرية. لكن الفاصل بين "ليالي الحلمية" نهاية الثمانينات وما اتخذه الخط البياني للدراما المصرية بعدها إلى الآن، هو محصلة فارق الموهبة الضخمة بين المبتكر الأول (أسامة أنور عكاشة) وبين من تتلمذوا على يديه من ناحية، كما هو الفارق بين لحظة إنتاج العمل الأول سياسياً واجتماعياً وبين اللحظات التالية وحتى الآن. فالمجتمع المصري شهد فيما بين اللحظتين تحولات عنيفة أصبحت الدراما خلالها تلعب أدواراً متباينة وفقاً لتغير ذوق الجمهور الذي تخاطبه، كذلك دخل عامل المنافسة غير المتكافئة مع انتاجات الدراما المحيطة اقليمياً دوراً في تعليب ذوق المصريين في أنماط بعينها تخص صورهم عن ذاتهم وما يأملون في مشاهدته عن أنفسهم. الدراما الاجتماعية، منذ منتصف التسعينات، تنحو الى التلصص على عوامل النخب الاقتصادية الجديدة والتي لن يشاهدها مواطن عادي في شوارع القاهرة، بل يمكن أن يتأقلم معها في مسلسلات عن الشر والرشاوى وعالم رجال الأعمال المشوه الذي هو في النهاية "شغل مسلسلات". كما اتجهت شريحة أخرى من المسلسلات لمخاطبة الحلم التقليدي للصعود الطبقي ممثلاً في تاجر خردة يصعد بالكفاح كما في "لن أعيش في جلباب أبي"، أو توجهت شريحة أخرى للمراهنة على المسلسلات ماركة "الترزي البلدي" وهي المسلسلات التي تعتمد على تفصيل 22 ساعة درامة على مقاس نجم أو نجمة.التاريخ يعود هذا العام في أكثر من موضع للدراما المصرية، سنتكلم هنا فقط عن العملين الأضخم انتاجياً وهما مسلسلي "حليم... حكاية شعب" و"السندريلا" بوصفهما مسلسلين يتخذان من التاريخ عمداً إحدى ركائزهما، ليس فقط بحكم كون عبدالحليم حافظ وسعاد حسني ينتميان لسردية تاريخية واحدة تتعلق بفترة من التاريخ المصري تمتد من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهايته، ولكن في ما قبل ذلك وبعده لذلك الإصرار من جانب مؤلف المسلسلين على تقديم كادر تاريخي متسع ينظم علاقة موضوع المسلسلين (سعاد حسني وعبدالحليم) بالأوضاع السياسية والإجتماعية التي تطورت كاريزماتهما ضمنها. من البداية وعبر اختيار عنوان مسلسل حليم عطفاً على "حكاية شعب"، يضع مدحت العدل مؤلف العمل مهمة ثقيلة على عاتقه، حيث يقدم العالم السياسي والاجتماعي المحيط بتطور موهبة عبدالحليم، لا في مداخلات محسوبة كماً وكيفاً من نص المسلسل، ولكن بأقرب الى سردية موازية ومتقاطعة عن عمد مع حياة عبدالحليم. السينارست هنا، وهو يتعامل مع شخصية لا تنتمي الى مرجعية نصية ممثلة في مذكرات مكتوبة بيد حليم، أو حتى في نص مكتوب لسيرته تحت إشرافه مضطر للسباحة الخطرة بين سيرورة تعتمد على نص شفاهي بامتياز، ممثلة في مقتطفات الصحف والمقابلات الإذاعية والصحافية أو ما ورد على لسان غيره. لم نعرف مرجعاً شاملاً أو كاملاً لشخصية عبدالحليم الحقيقية، خصوصاً في ما يتعلق بحياته قبل نجوميته الزاعقة. لذا يبدو الحديث عن طفولته درامياً رهين الخيال الرومانتيكي عن إبن قرية "الحلوات" اليتيم وعائلته الفقيرة، وهي الدراما التي استطاع حليم نفسه أن يكرسها في الأذهان لاحقاً وعبر مسيرته الطويلة. إلا أنها وحدها ربما ونتيجة لفقرها الشديد وإيجازها المخلّ لا تصلح وحدها لملء فراغات تلك السردية. هنا كان لا بد من اللحاق بنصوص ذات وجاهة درامية فاقعة تتمثل في الحراك السياسي في القاهرة ممثلاً في أنشطة حسن البنا وجماعة الإخوان والوفد والشيوعيين. وكأن ابن القرية البعيدة الواقعة في شرق الدلتا كان مدركاً لطبيعة تلك الصراعات العنيفة في مدينة نجوميته المستقبلية.المؤسف بحق أن الشخصية الحقيقية المترسبة عبر التاريخ لحليم ربما لا ترشح مثل هذا التناص. فما عرف عن النجم الراحل كان عدم اهتمامه بالسياسة أساساً، وتحديداً كان ذلك من عوامل الجذب الشديدة في شخصيته عندما اختارته الثورة بشكل تقاطعي ليصبح صوتها الأهم. يبذل السينارست مجهوداً شكلانياً جباراً لربط مسيرة حياة المطرب الناشئ بالتطور الذي نتوقعه له مستقبلاً. فنرى حسن البنا وعلاقاته التنظيمية لأول مرة على شاشة مصرية عروجاً على علاقة تعاطف بعيدة لأحد أقارب حليم مع أفكار جماعة الإخوان المسلمين. هل هو الميل الى التأريخ من دون مناسبة ما يدفع مدحت العدل لتشبيك تلك الخطوط الواهية درامياً ببعضها البعض؟ أم أن غموض تلك المرحلة في شخصية حليم احتاجت الى حشو ذي نبرة عالية للتغطية على الفجوات العميقة والحقيقية؟ الأزمة لدى مدحت العدل متأصلة في ذلك الجنوح الى التأريخ، فالعام الماضي قدم مسلسلاً بعنوان "محمود المصري" ابتدع خلاله حشواً تاريخياً ممجوجاً لقصة الصعود الطبقي لأحد الكرتلات الاقتصادية المصرية في الخارج ـ أشيع أنها قصة الملياردير المصري محمد الفايد صاحب سلسلة محلات هاوردز اللندنية الشهيرة ـ حيث التقاطعات السردية مع فساد مصر الملكية ثم مصر الجمهورية الناصرية ثم العودة لفساد السبعينات التي مثلت الخلفية لهروب ثم عودة ثم هروب الشخصية الرئيسية. مع كامل الإكسسوار الذي يبدع من خلاله مدحت العدل حين يعرج على التنظيمات اليسارية في السبعينات من خلال شخصية فرعية، ولإكمال المشهد، لا بد من راكور الشاب المتطرف دينياً، والكل لخدمة ضعف الحكاية الدرامية البسيطة لصعود بطله محمود المصري.التاريخ كحالة إكسسوارية يطفح هذه المرة مع حليم، ويجري تعميقه من خلال ضبط شكلاني مريع في دقته: الملابس والديكورات والتقمص الشكلاني للممثلين في أدوار ثانوية أحاطت بحليم مثل كمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وصلاح جاهين، هذه الأسماء الضخمة، بالإضافة للسياسيين والصحافيين الكبار والتي بالغ المخرج في استعراض حجم المطابقة الشكلية للممثلين مع أصحابها، يجعل من مسلسل حليم عرضاً للمشخصاتية، حيث يحاول ناسج الخطوط الدرامية أن يضع في كل مشاهده تلك الإيقونات في أبهى حللها وكأنه يبحث عن تفخيم مبالغ فيه للعمل. كل الشخصيات تنطق بروح المشخصاتي لا الممثل، مشاهد كاملة داخل الحلقات المعروضة حتى الآن مفتعلة افتعالاً غير مسبوق، وكأن المخرج والسينارست يحاولان التعمية على ضعف أداء الشخصية الرئيسية والتي يقدمها الممثل شادي شامل. هذا الأخير هو أكبر مصائب المسلسل حيث لم يخرج بالشخصية من على مسرح المقلداتي. لم ينزل شادي شامل حتى الآن من على مسرح قناة الـ"إم بي سي"، لم يبحث مثلاً كيف كان أداء حليم الشخصي فيزيقياً ومشاعرياً خارج طلته الكاريكاتيرية على المسرح وهو يغني في نهاية عمره. ليس من الممكن أن يكون حليم بهذه التفاهة التي تطالعنا في كل مشهد يطل من خلاله شادي شامل، ذلك التهتك المبتذل والمكياج الصاخب الذي يصاحبه حتى وهو نائم في فراشه قبل أن يشتهر، في أحد المشاهد تدخل عبلة كامل ـ إحدى الفضائح التقليدية الآن في الدراما المصرية ـ التي تقوم بدور شقيقة حليم "علية" لتوقظه من النوم، فيطل علينا حليم بكامل شعره المصفف والمسشور من تحت البطانية حتى قبل أن يفرك عينه. ما أن يطل شادي شامل بأراجوزية أدئه الطافحة حتى تشعر بأن المسلسل بكامله في مقام المسلسل الكوميدي أو كفقرة تقليد السينما على إحدى القنوات الفضائية. ولا بد هنا من القياس فقد قدمت الدراما المصرية منذ ما يزيد عن العشرين عاماً مسلسل "الأيام" المأخوذ عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين. وعلى الرغم من فارق الإمكانات المادية والتقنية بين اللحظتين، لكننا حتى هذه اللحظة، وعند تخيل عميد الأدب العربي، نحتاج لفصله بقوة عما قدمه العملاق أحمد زكي. لم يلجأ كاتب دراما "الأيام" لأي إكسسوار تاريخي خارج نص العميد، الحياة الشقية والفقيرة للطفل طه حسين وصراعه مع المرض والعمى. رغم بساطة الطاقة الدرامية فقد تسمرنا أمام المسلسل لنحو عشر حلقات كاملة. أعرف أن المقارنة بعمل يعود بسرديته الى نص أدبي بديع مثل "الأيام" مقارنة ظالمة، إلا أن الأداء المبهر لأمينة رزق ويحيى شاهين والطفل شريف عبدالمحسن، ثم أخيراً ومن خلف الجميع، العملاق أحمد زكي، ثم المقادير الدرامية المبثوثة عبر تدرجات العمل، ألزمت ذاكرتنا على حفظ جمل طويلة من حواراته ومشاهده. أين هذا من مسلسل تدخل حلقاته الى منتصف الشهر دون أن يستطيع إقناعنا بأن من نراه على الشاشة هو عبدالحليم حافظ بكل مدلولات الكلمة من سحر وتشويق. المعالجة الدرامية التي تتعكز على التاريخ السياسي دون مبرر تُبهت ربما عن عمد إطلالات حليم المزيف. فإذا ما أضفنا بهوت وكلاشيهية معالجة ذلك التاريخ حين ينحصر دور المعالجة في تلبيس ما هو شفاهي من سردية تلك الأيام ثوب واقعية ممجوجة بمكياج ثقيل ومقاربات شكلية لأبطال المرحلة منزوعة الروح والسياق، تجعلنا أمام إسكتش هزلي للتاريخ بحجم مسلسل طويل مملّ. في الحلقة التاسعة من المسلسل، وبعد متتالية مشاهد لرحلة حليم الفاشلة للغناء بالاسكندرية عام 1951، يتذكر المؤلف محور "ثورة يوليو" فيعود للضباط الأحرار في متتالية ثانية وطويلة هي الأخرى تبدأ بعبد الناصر منتظراً نتيجة انتخابات نادي الضباط ثم حوارمع زوجته، ثم بخروجه من المنزل تحت المراقبة، ثم بهروبه من المراقبة، ثم بلقائه قيادات الضباط الأحرار شارحاً ضرورة التحرك السريع للقيام بالثورة مع تقطيع مواز للسرايا حيث قيادة البوليس تخطط للقبض عليهم، ثم العودة الى محاولات ناصر ورفاقه مواجهة الملك. من يفتح التلفزيون منذ عشر دقائق على الأقل وحتى نهاية الحلقة سيعتقد أن المسلسل عن ثورة يوليو، أين حليم من هذا؟ ثم لماذا الإصرار على ربط حراك حليم وصعوده قبل الثورة برباط الوطنية. في أحد المشاهد التي تؤكد على آلية الربط اللامنطقية يسأل حليم أخاه الضابط عن هموم الجيش، فيخرج الأخ بياناً للضباط الأحرار، فيتنبأ حليم بالثورة؟ ليس هناك بالطبع أي مرجعية تاريخية تؤكدأو تنفي هذا المشهد، فالمشهد مبتكر في فجاجته ويخص الخيال التلفيقي لمدحت العدل. ويبدو أن الجمهور الذي يتعامل مع تلك المرحلة على أنها حلم، هذا الجمهور تحديداً قد أصبح مؤهلاً لتجاوز ركاكة وهشاشة المزج المتعمد بين أرجوز على هيئة حليم وبين الثورة والفن والسياسة، فخلاّط الدراما المصرية لا جناح عليه طالما تاريخ تلك المرحلة نفسها قد تُرك عمداً في غياهب ضباب كثيف. تركت فترة الأحلام الكبرى عرضة لهزل الأحفاد، تُركت كي تتحول على شاشة الإعلانات الى فاصل درامي يتعامل مع التاريخ كإكسسوار براق لبيع بضاعة فاسدة.
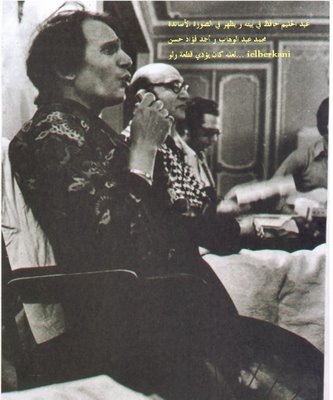 السيناريست أسامة أنور عكاشة مثّل ملكاً متوجاً لذلك المنحى، هو الفاشل في الكتابة الروائية دخلت معه الدراما المصرية مرحلة "الرواية التلفزيونية" مستمداً من تراث نجيب محفوظ القدرة على بناء الشجرة العائلية الممتدة والخطوط الدرامية المتقاطعة. كان أسامة الساحر الأول لتلك النوعية عندما جعل خطوطه الدرامية البعيدة عن الزخرفة تتقاطع بحنكة مدربة مع ما هو سياسي. والمتابع لسردية "ليالي الحلمية" المبنية على منظومة التداخلات الطبقية للحي الشهير، والتي تربط بوشائج عنيفة علاقات ساكني قصوره بالحارات الخلفية، يدرك إحدى أهم سمات الاشتباك الاجتماعي السياسي فاعلية في الدراما المصرية. لكن الفاصل بين "ليالي الحلمية" نهاية الثمانينات وما اتخذه الخط البياني للدراما المصرية بعدها إلى الآن، هو محصلة فارق الموهبة الضخمة بين المبتكر الأول (أسامة أنور عكاشة) وبين من تتلمذوا على يديه من ناحية، كما هو الفارق بين لحظة إنتاج العمل الأول سياسياً واجتماعياً وبين اللحظات التالية وحتى الآن. فالمجتمع المصري شهد فيما بين اللحظتين تحولات عنيفة أصبحت الدراما خلالها تلعب أدواراً متباينة وفقاً لتغير ذوق الجمهور الذي تخاطبه، كذلك دخل عامل المنافسة غير المتكافئة مع انتاجات الدراما المحيطة اقليمياً دوراً في تعليب ذوق المصريين في أنماط بعينها تخص صورهم عن ذاتهم وما يأملون في مشاهدته عن أنفسهم. الدراما الاجتماعية، منذ منتصف التسعينات، تنحو الى التلصص على عوامل النخب الاقتصادية الجديدة والتي لن يشاهدها مواطن عادي في شوارع القاهرة، بل يمكن أن يتأقلم معها في مسلسلات عن الشر والرشاوى وعالم رجال الأعمال المشوه الذي هو في النهاية "شغل مسلسلات". كما اتجهت شريحة أخرى من المسلسلات لمخاطبة الحلم التقليدي للصعود الطبقي ممثلاً في تاجر خردة يصعد بالكفاح كما في "لن أعيش في جلباب أبي"، أو توجهت شريحة أخرى للمراهنة على المسلسلات ماركة "الترزي البلدي" وهي المسلسلات التي تعتمد على تفصيل 22 ساعة درامة على مقاس نجم أو نجمة.التاريخ يعود هذا العام في أكثر من موضع للدراما المصرية، سنتكلم هنا فقط عن العملين الأضخم انتاجياً وهما مسلسلي "حليم... حكاية شعب" و"السندريلا" بوصفهما مسلسلين يتخذان من التاريخ عمداً إحدى ركائزهما، ليس فقط بحكم كون عبدالحليم حافظ وسعاد حسني ينتميان لسردية تاريخية واحدة تتعلق بفترة من التاريخ المصري تمتد من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهايته، ولكن في ما قبل ذلك وبعده لذلك الإصرار من جانب مؤلف المسلسلين على تقديم كادر تاريخي متسع ينظم علاقة موضوع المسلسلين (سعاد حسني وعبدالحليم) بالأوضاع السياسية والإجتماعية التي تطورت كاريزماتهما ضمنها. من البداية وعبر اختيار عنوان مسلسل حليم عطفاً على "حكاية شعب"، يضع مدحت العدل مؤلف العمل مهمة ثقيلة على عاتقه، حيث يقدم العالم السياسي والاجتماعي المحيط بتطور موهبة عبدالحليم، لا في مداخلات محسوبة كماً وكيفاً من نص المسلسل، ولكن بأقرب الى سردية موازية ومتقاطعة عن عمد مع حياة عبدالحليم. السينارست هنا، وهو يتعامل مع شخصية لا تنتمي الى مرجعية نصية ممثلة في مذكرات مكتوبة بيد حليم، أو حتى في نص مكتوب لسيرته تحت إشرافه مضطر للسباحة الخطرة بين سيرورة تعتمد على نص شفاهي بامتياز، ممثلة في مقتطفات الصحف والمقابلات الإذاعية والصحافية أو ما ورد على لسان غيره. لم نعرف مرجعاً شاملاً أو كاملاً لشخصية عبدالحليم الحقيقية، خصوصاً في ما يتعلق بحياته قبل نجوميته الزاعقة. لذا يبدو الحديث عن طفولته درامياً رهين الخيال الرومانتيكي عن إبن قرية "الحلوات" اليتيم وعائلته الفقيرة، وهي الدراما التي استطاع حليم نفسه أن يكرسها في الأذهان لاحقاً وعبر مسيرته الطويلة. إلا أنها وحدها ربما ونتيجة لفقرها الشديد وإيجازها المخلّ لا تصلح وحدها لملء فراغات تلك السردية. هنا كان لا بد من اللحاق بنصوص ذات وجاهة درامية فاقعة تتمثل في الحراك السياسي في القاهرة ممثلاً في أنشطة حسن البنا وجماعة الإخوان والوفد والشيوعيين. وكأن ابن القرية البعيدة الواقعة في شرق الدلتا كان مدركاً لطبيعة تلك الصراعات العنيفة في مدينة نجوميته المستقبلية.المؤسف بحق أن الشخصية الحقيقية المترسبة عبر التاريخ لحليم ربما لا ترشح مثل هذا التناص. فما عرف عن النجم الراحل كان عدم اهتمامه بالسياسة أساساً، وتحديداً كان ذلك من عوامل الجذب الشديدة في شخصيته عندما اختارته الثورة بشكل تقاطعي ليصبح صوتها الأهم. يبذل السينارست مجهوداً شكلانياً جباراً لربط مسيرة حياة المطرب الناشئ بالتطور الذي نتوقعه له مستقبلاً. فنرى حسن البنا وعلاقاته التنظيمية لأول مرة على شاشة مصرية عروجاً على علاقة تعاطف بعيدة لأحد أقارب حليم مع أفكار جماعة الإخوان المسلمين. هل هو الميل الى التأريخ من دون مناسبة ما يدفع مدحت العدل لتشبيك تلك الخطوط الواهية درامياً ببعضها البعض؟ أم أن غموض تلك المرحلة في شخصية حليم احتاجت الى حشو ذي نبرة عالية للتغطية على الفجوات العميقة والحقيقية؟ الأزمة لدى مدحت العدل متأصلة في ذلك الجنوح الى التأريخ، فالعام الماضي قدم مسلسلاً بعنوان "محمود المصري" ابتدع خلاله حشواً تاريخياً ممجوجاً لقصة الصعود الطبقي لأحد الكرتلات الاقتصادية المصرية في الخارج ـ أشيع أنها قصة الملياردير المصري محمد الفايد صاحب سلسلة محلات هاوردز اللندنية الشهيرة ـ حيث التقاطعات السردية مع فساد مصر الملكية ثم مصر الجمهورية الناصرية ثم العودة لفساد السبعينات التي مثلت الخلفية لهروب ثم عودة ثم هروب الشخصية الرئيسية. مع كامل الإكسسوار الذي يبدع من خلاله مدحت العدل حين يعرج على التنظيمات اليسارية في السبعينات من خلال شخصية فرعية، ولإكمال المشهد، لا بد من راكور الشاب المتطرف دينياً، والكل لخدمة ضعف الحكاية الدرامية البسيطة لصعود بطله محمود المصري.التاريخ كحالة إكسسوارية يطفح هذه المرة مع حليم، ويجري تعميقه من خلال ضبط شكلاني مريع في دقته: الملابس والديكورات والتقمص الشكلاني للممثلين في أدوار ثانوية أحاطت بحليم مثل كمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وصلاح جاهين، هذه الأسماء الضخمة، بالإضافة للسياسيين والصحافيين الكبار والتي بالغ المخرج في استعراض حجم المطابقة الشكلية للممثلين مع أصحابها، يجعل من مسلسل حليم عرضاً للمشخصاتية، حيث يحاول ناسج الخطوط الدرامية أن يضع في كل مشاهده تلك الإيقونات في أبهى حللها وكأنه يبحث عن تفخيم مبالغ فيه للعمل. كل الشخصيات تنطق بروح المشخصاتي لا الممثل، مشاهد كاملة داخل الحلقات المعروضة حتى الآن مفتعلة افتعالاً غير مسبوق، وكأن المخرج والسينارست يحاولان التعمية على ضعف أداء الشخصية الرئيسية والتي يقدمها الممثل شادي شامل. هذا الأخير هو أكبر مصائب المسلسل حيث لم يخرج بالشخصية من على مسرح المقلداتي. لم ينزل شادي شامل حتى الآن من على مسرح قناة الـ"إم بي سي"، لم يبحث مثلاً كيف كان أداء حليم الشخصي فيزيقياً ومشاعرياً خارج طلته الكاريكاتيرية على المسرح وهو يغني في نهاية عمره. ليس من الممكن أن يكون حليم بهذه التفاهة التي تطالعنا في كل مشهد يطل من خلاله شادي شامل، ذلك التهتك المبتذل والمكياج الصاخب الذي يصاحبه حتى وهو نائم في فراشه قبل أن يشتهر، في أحد المشاهد تدخل عبلة كامل ـ إحدى الفضائح التقليدية الآن في الدراما المصرية ـ التي تقوم بدور شقيقة حليم "علية" لتوقظه من النوم، فيطل علينا حليم بكامل شعره المصفف والمسشور من تحت البطانية حتى قبل أن يفرك عينه. ما أن يطل شادي شامل بأراجوزية أدئه الطافحة حتى تشعر بأن المسلسل بكامله في مقام المسلسل الكوميدي أو كفقرة تقليد السينما على إحدى القنوات الفضائية. ولا بد هنا من القياس فقد قدمت الدراما المصرية منذ ما يزيد عن العشرين عاماً مسلسل "الأيام" المأخوذ عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين. وعلى الرغم من فارق الإمكانات المادية والتقنية بين اللحظتين، لكننا حتى هذه اللحظة، وعند تخيل عميد الأدب العربي، نحتاج لفصله بقوة عما قدمه العملاق أحمد زكي. لم يلجأ كاتب دراما "الأيام" لأي إكسسوار تاريخي خارج نص العميد، الحياة الشقية والفقيرة للطفل طه حسين وصراعه مع المرض والعمى. رغم بساطة الطاقة الدرامية فقد تسمرنا أمام المسلسل لنحو عشر حلقات كاملة. أعرف أن المقارنة بعمل يعود بسرديته الى نص أدبي بديع مثل "الأيام" مقارنة ظالمة، إلا أن الأداء المبهر لأمينة رزق ويحيى شاهين والطفل شريف عبدالمحسن، ثم أخيراً ومن خلف الجميع، العملاق أحمد زكي، ثم المقادير الدرامية المبثوثة عبر تدرجات العمل، ألزمت ذاكرتنا على حفظ جمل طويلة من حواراته ومشاهده. أين هذا من مسلسل تدخل حلقاته الى منتصف الشهر دون أن يستطيع إقناعنا بأن من نراه على الشاشة هو عبدالحليم حافظ بكل مدلولات الكلمة من سحر وتشويق. المعالجة الدرامية التي تتعكز على التاريخ السياسي دون مبرر تُبهت ربما عن عمد إطلالات حليم المزيف. فإذا ما أضفنا بهوت وكلاشيهية معالجة ذلك التاريخ حين ينحصر دور المعالجة في تلبيس ما هو شفاهي من سردية تلك الأيام ثوب واقعية ممجوجة بمكياج ثقيل ومقاربات شكلية لأبطال المرحلة منزوعة الروح والسياق، تجعلنا أمام إسكتش هزلي للتاريخ بحجم مسلسل طويل مملّ. في الحلقة التاسعة من المسلسل، وبعد متتالية مشاهد لرحلة حليم الفاشلة للغناء بالاسكندرية عام 1951، يتذكر المؤلف محور "ثورة يوليو" فيعود للضباط الأحرار في متتالية ثانية وطويلة هي الأخرى تبدأ بعبد الناصر منتظراً نتيجة انتخابات نادي الضباط ثم حوارمع زوجته، ثم بخروجه من المنزل تحت المراقبة، ثم بهروبه من المراقبة، ثم بلقائه قيادات الضباط الأحرار شارحاً ضرورة التحرك السريع للقيام بالثورة مع تقطيع مواز للسرايا حيث قيادة البوليس تخطط للقبض عليهم، ثم العودة الى محاولات ناصر ورفاقه مواجهة الملك. من يفتح التلفزيون منذ عشر دقائق على الأقل وحتى نهاية الحلقة سيعتقد أن المسلسل عن ثورة يوليو، أين حليم من هذا؟ ثم لماذا الإصرار على ربط حراك حليم وصعوده قبل الثورة برباط الوطنية. في أحد المشاهد التي تؤكد على آلية الربط اللامنطقية يسأل حليم أخاه الضابط عن هموم الجيش، فيخرج الأخ بياناً للضباط الأحرار، فيتنبأ حليم بالثورة؟ ليس هناك بالطبع أي مرجعية تاريخية تؤكدأو تنفي هذا المشهد، فالمشهد مبتكر في فجاجته ويخص الخيال التلفيقي لمدحت العدل. ويبدو أن الجمهور الذي يتعامل مع تلك المرحلة على أنها حلم، هذا الجمهور تحديداً قد أصبح مؤهلاً لتجاوز ركاكة وهشاشة المزج المتعمد بين أرجوز على هيئة حليم وبين الثورة والفن والسياسة، فخلاّط الدراما المصرية لا جناح عليه طالما تاريخ تلك المرحلة نفسها قد تُرك عمداً في غياهب ضباب كثيف. تركت فترة الأحلام الكبرى عرضة لهزل الأحفاد، تُركت كي تتحول على شاشة الإعلانات الى فاصل درامي يتعامل مع التاريخ كإكسسوار براق لبيع بضاعة فاسدة.
السيناريست أسامة أنور عكاشة مثّل ملكاً متوجاً لذلك المنحى، هو الفاشل في الكتابة الروائية دخلت معه الدراما المصرية مرحلة "الرواية التلفزيونية" مستمداً من تراث نجيب محفوظ القدرة على بناء الشجرة العائلية الممتدة والخطوط الدرامية المتقاطعة. كان أسامة الساحر الأول لتلك النوعية عندما جعل خطوطه الدرامية البعيدة عن الزخرفة تتقاطع بحنكة مدربة مع ما هو سياسي. والمتابع لسردية "ليالي الحلمية" المبنية على منظومة التداخلات الطبقية للحي الشهير، والتي تربط بوشائج عنيفة علاقات ساكني قصوره بالحارات الخلفية، يدرك إحدى أهم سمات الاشتباك الاجتماعي السياسي فاعلية في الدراما المصرية. لكن الفاصل بين "ليالي الحلمية" نهاية الثمانينات وما اتخذه الخط البياني للدراما المصرية بعدها إلى الآن، هو محصلة فارق الموهبة الضخمة بين المبتكر الأول (أسامة أنور عكاشة) وبين من تتلمذوا على يديه من ناحية، كما هو الفارق بين لحظة إنتاج العمل الأول سياسياً واجتماعياً وبين اللحظات التالية وحتى الآن. فالمجتمع المصري شهد فيما بين اللحظتين تحولات عنيفة أصبحت الدراما خلالها تلعب أدواراً متباينة وفقاً لتغير ذوق الجمهور الذي تخاطبه، كذلك دخل عامل المنافسة غير المتكافئة مع انتاجات الدراما المحيطة اقليمياً دوراً في تعليب ذوق المصريين في أنماط بعينها تخص صورهم عن ذاتهم وما يأملون في مشاهدته عن أنفسهم. الدراما الاجتماعية، منذ منتصف التسعينات، تنحو الى التلصص على عوامل النخب الاقتصادية الجديدة والتي لن يشاهدها مواطن عادي في شوارع القاهرة، بل يمكن أن يتأقلم معها في مسلسلات عن الشر والرشاوى وعالم رجال الأعمال المشوه الذي هو في النهاية "شغل مسلسلات". كما اتجهت شريحة أخرى من المسلسلات لمخاطبة الحلم التقليدي للصعود الطبقي ممثلاً في تاجر خردة يصعد بالكفاح كما في "لن أعيش في جلباب أبي"، أو توجهت شريحة أخرى للمراهنة على المسلسلات ماركة "الترزي البلدي" وهي المسلسلات التي تعتمد على تفصيل 22 ساعة درامة على مقاس نجم أو نجمة.التاريخ يعود هذا العام في أكثر من موضع للدراما المصرية، سنتكلم هنا فقط عن العملين الأضخم انتاجياً وهما مسلسلي "حليم... حكاية شعب" و"السندريلا" بوصفهما مسلسلين يتخذان من التاريخ عمداً إحدى ركائزهما، ليس فقط بحكم كون عبدالحليم حافظ وسعاد حسني ينتميان لسردية تاريخية واحدة تتعلق بفترة من التاريخ المصري تمتد من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهايته، ولكن في ما قبل ذلك وبعده لذلك الإصرار من جانب مؤلف المسلسلين على تقديم كادر تاريخي متسع ينظم علاقة موضوع المسلسلين (سعاد حسني وعبدالحليم) بالأوضاع السياسية والإجتماعية التي تطورت كاريزماتهما ضمنها. من البداية وعبر اختيار عنوان مسلسل حليم عطفاً على "حكاية شعب"، يضع مدحت العدل مؤلف العمل مهمة ثقيلة على عاتقه، حيث يقدم العالم السياسي والاجتماعي المحيط بتطور موهبة عبدالحليم، لا في مداخلات محسوبة كماً وكيفاً من نص المسلسل، ولكن بأقرب الى سردية موازية ومتقاطعة عن عمد مع حياة عبدالحليم. السينارست هنا، وهو يتعامل مع شخصية لا تنتمي الى مرجعية نصية ممثلة في مذكرات مكتوبة بيد حليم، أو حتى في نص مكتوب لسيرته تحت إشرافه مضطر للسباحة الخطرة بين سيرورة تعتمد على نص شفاهي بامتياز، ممثلة في مقتطفات الصحف والمقابلات الإذاعية والصحافية أو ما ورد على لسان غيره. لم نعرف مرجعاً شاملاً أو كاملاً لشخصية عبدالحليم الحقيقية، خصوصاً في ما يتعلق بحياته قبل نجوميته الزاعقة. لذا يبدو الحديث عن طفولته درامياً رهين الخيال الرومانتيكي عن إبن قرية "الحلوات" اليتيم وعائلته الفقيرة، وهي الدراما التي استطاع حليم نفسه أن يكرسها في الأذهان لاحقاً وعبر مسيرته الطويلة. إلا أنها وحدها ربما ونتيجة لفقرها الشديد وإيجازها المخلّ لا تصلح وحدها لملء فراغات تلك السردية. هنا كان لا بد من اللحاق بنصوص ذات وجاهة درامية فاقعة تتمثل في الحراك السياسي في القاهرة ممثلاً في أنشطة حسن البنا وجماعة الإخوان والوفد والشيوعيين. وكأن ابن القرية البعيدة الواقعة في شرق الدلتا كان مدركاً لطبيعة تلك الصراعات العنيفة في مدينة نجوميته المستقبلية.المؤسف بحق أن الشخصية الحقيقية المترسبة عبر التاريخ لحليم ربما لا ترشح مثل هذا التناص. فما عرف عن النجم الراحل كان عدم اهتمامه بالسياسة أساساً، وتحديداً كان ذلك من عوامل الجذب الشديدة في شخصيته عندما اختارته الثورة بشكل تقاطعي ليصبح صوتها الأهم. يبذل السينارست مجهوداً شكلانياً جباراً لربط مسيرة حياة المطرب الناشئ بالتطور الذي نتوقعه له مستقبلاً. فنرى حسن البنا وعلاقاته التنظيمية لأول مرة على شاشة مصرية عروجاً على علاقة تعاطف بعيدة لأحد أقارب حليم مع أفكار جماعة الإخوان المسلمين. هل هو الميل الى التأريخ من دون مناسبة ما يدفع مدحت العدل لتشبيك تلك الخطوط الواهية درامياً ببعضها البعض؟ أم أن غموض تلك المرحلة في شخصية حليم احتاجت الى حشو ذي نبرة عالية للتغطية على الفجوات العميقة والحقيقية؟ الأزمة لدى مدحت العدل متأصلة في ذلك الجنوح الى التأريخ، فالعام الماضي قدم مسلسلاً بعنوان "محمود المصري" ابتدع خلاله حشواً تاريخياً ممجوجاً لقصة الصعود الطبقي لأحد الكرتلات الاقتصادية المصرية في الخارج ـ أشيع أنها قصة الملياردير المصري محمد الفايد صاحب سلسلة محلات هاوردز اللندنية الشهيرة ـ حيث التقاطعات السردية مع فساد مصر الملكية ثم مصر الجمهورية الناصرية ثم العودة لفساد السبعينات التي مثلت الخلفية لهروب ثم عودة ثم هروب الشخصية الرئيسية. مع كامل الإكسسوار الذي يبدع من خلاله مدحت العدل حين يعرج على التنظيمات اليسارية في السبعينات من خلال شخصية فرعية، ولإكمال المشهد، لا بد من راكور الشاب المتطرف دينياً، والكل لخدمة ضعف الحكاية الدرامية البسيطة لصعود بطله محمود المصري.التاريخ كحالة إكسسوارية يطفح هذه المرة مع حليم، ويجري تعميقه من خلال ضبط شكلاني مريع في دقته: الملابس والديكورات والتقمص الشكلاني للممثلين في أدوار ثانوية أحاطت بحليم مثل كمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وصلاح جاهين، هذه الأسماء الضخمة، بالإضافة للسياسيين والصحافيين الكبار والتي بالغ المخرج في استعراض حجم المطابقة الشكلية للممثلين مع أصحابها، يجعل من مسلسل حليم عرضاً للمشخصاتية، حيث يحاول ناسج الخطوط الدرامية أن يضع في كل مشاهده تلك الإيقونات في أبهى حللها وكأنه يبحث عن تفخيم مبالغ فيه للعمل. كل الشخصيات تنطق بروح المشخصاتي لا الممثل، مشاهد كاملة داخل الحلقات المعروضة حتى الآن مفتعلة افتعالاً غير مسبوق، وكأن المخرج والسينارست يحاولان التعمية على ضعف أداء الشخصية الرئيسية والتي يقدمها الممثل شادي شامل. هذا الأخير هو أكبر مصائب المسلسل حيث لم يخرج بالشخصية من على مسرح المقلداتي. لم ينزل شادي شامل حتى الآن من على مسرح قناة الـ"إم بي سي"، لم يبحث مثلاً كيف كان أداء حليم الشخصي فيزيقياً ومشاعرياً خارج طلته الكاريكاتيرية على المسرح وهو يغني في نهاية عمره. ليس من الممكن أن يكون حليم بهذه التفاهة التي تطالعنا في كل مشهد يطل من خلاله شادي شامل، ذلك التهتك المبتذل والمكياج الصاخب الذي يصاحبه حتى وهو نائم في فراشه قبل أن يشتهر، في أحد المشاهد تدخل عبلة كامل ـ إحدى الفضائح التقليدية الآن في الدراما المصرية ـ التي تقوم بدور شقيقة حليم "علية" لتوقظه من النوم، فيطل علينا حليم بكامل شعره المصفف والمسشور من تحت البطانية حتى قبل أن يفرك عينه. ما أن يطل شادي شامل بأراجوزية أدئه الطافحة حتى تشعر بأن المسلسل بكامله في مقام المسلسل الكوميدي أو كفقرة تقليد السينما على إحدى القنوات الفضائية. ولا بد هنا من القياس فقد قدمت الدراما المصرية منذ ما يزيد عن العشرين عاماً مسلسل "الأيام" المأخوذ عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين. وعلى الرغم من فارق الإمكانات المادية والتقنية بين اللحظتين، لكننا حتى هذه اللحظة، وعند تخيل عميد الأدب العربي، نحتاج لفصله بقوة عما قدمه العملاق أحمد زكي. لم يلجأ كاتب دراما "الأيام" لأي إكسسوار تاريخي خارج نص العميد، الحياة الشقية والفقيرة للطفل طه حسين وصراعه مع المرض والعمى. رغم بساطة الطاقة الدرامية فقد تسمرنا أمام المسلسل لنحو عشر حلقات كاملة. أعرف أن المقارنة بعمل يعود بسرديته الى نص أدبي بديع مثل "الأيام" مقارنة ظالمة، إلا أن الأداء المبهر لأمينة رزق ويحيى شاهين والطفل شريف عبدالمحسن، ثم أخيراً ومن خلف الجميع، العملاق أحمد زكي، ثم المقادير الدرامية المبثوثة عبر تدرجات العمل، ألزمت ذاكرتنا على حفظ جمل طويلة من حواراته ومشاهده. أين هذا من مسلسل تدخل حلقاته الى منتصف الشهر دون أن يستطيع إقناعنا بأن من نراه على الشاشة هو عبدالحليم حافظ بكل مدلولات الكلمة من سحر وتشويق. المعالجة الدرامية التي تتعكز على التاريخ السياسي دون مبرر تُبهت ربما عن عمد إطلالات حليم المزيف. فإذا ما أضفنا بهوت وكلاشيهية معالجة ذلك التاريخ حين ينحصر دور المعالجة في تلبيس ما هو شفاهي من سردية تلك الأيام ثوب واقعية ممجوجة بمكياج ثقيل ومقاربات شكلية لأبطال المرحلة منزوعة الروح والسياق، تجعلنا أمام إسكتش هزلي للتاريخ بحجم مسلسل طويل مملّ. في الحلقة التاسعة من المسلسل، وبعد متتالية مشاهد لرحلة حليم الفاشلة للغناء بالاسكندرية عام 1951، يتذكر المؤلف محور "ثورة يوليو" فيعود للضباط الأحرار في متتالية ثانية وطويلة هي الأخرى تبدأ بعبد الناصر منتظراً نتيجة انتخابات نادي الضباط ثم حوارمع زوجته، ثم بخروجه من المنزل تحت المراقبة، ثم بهروبه من المراقبة، ثم بلقائه قيادات الضباط الأحرار شارحاً ضرورة التحرك السريع للقيام بالثورة مع تقطيع مواز للسرايا حيث قيادة البوليس تخطط للقبض عليهم، ثم العودة الى محاولات ناصر ورفاقه مواجهة الملك. من يفتح التلفزيون منذ عشر دقائق على الأقل وحتى نهاية الحلقة سيعتقد أن المسلسل عن ثورة يوليو، أين حليم من هذا؟ ثم لماذا الإصرار على ربط حراك حليم وصعوده قبل الثورة برباط الوطنية. في أحد المشاهد التي تؤكد على آلية الربط اللامنطقية يسأل حليم أخاه الضابط عن هموم الجيش، فيخرج الأخ بياناً للضباط الأحرار، فيتنبأ حليم بالثورة؟ ليس هناك بالطبع أي مرجعية تاريخية تؤكدأو تنفي هذا المشهد، فالمشهد مبتكر في فجاجته ويخص الخيال التلفيقي لمدحت العدل. ويبدو أن الجمهور الذي يتعامل مع تلك المرحلة على أنها حلم، هذا الجمهور تحديداً قد أصبح مؤهلاً لتجاوز ركاكة وهشاشة المزج المتعمد بين أرجوز على هيئة حليم وبين الثورة والفن والسياسة، فخلاّط الدراما المصرية لا جناح عليه طالما تاريخ تلك المرحلة نفسها قد تُرك عمداً في غياهب ضباب كثيف. تركت فترة الأحلام الكبرى عرضة لهزل الأحفاد، تُركت كي تتحول على شاشة الإعلانات الى فاصل درامي يتعامل مع التاريخ كإكسسوار براق لبيع بضاعة فاسدة.

0 Comments:
إرسال تعليق
<< Home